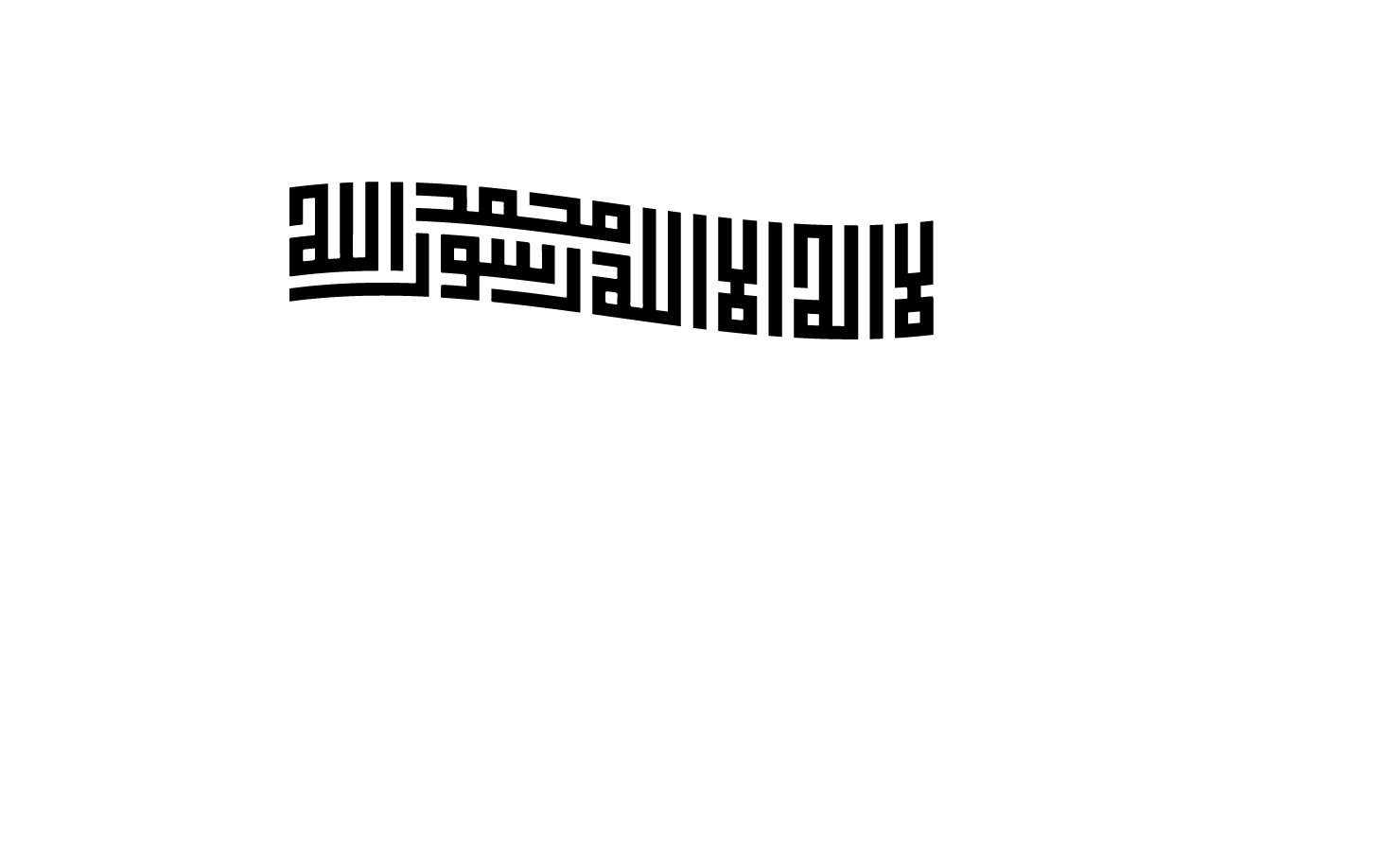كلّ إنسان يدّعي النبوة، لا بدّ أن يبرهن على صدقه، وأن يكون قادرا على الإتيان بدليل على دعم الله له. وهذا الدليل هو الإتيان بظاهرة تتحدى القوانين الطبيعية يعجز عن الإتيان بها الإنسان، فيتحتم أن يكون الذي أنشأ هذه الظاهرة هو الله ليثبت أن الشخص الذي أتى بها هو نبي مرسل منه. أو بتعبير آخر، أن يأتي هذا النبي بمعجزة.
والحقيقة أن كل الرسل والأنبياء أُيِّدوا بمعجزات. إبراهيم (عليه السلام) أعلم قومه بأنه رسول إليهم من الله ليبلغهم رسالته. وكدليل على صدقه، شاهد الناس العديد من المعجزات على يد إبراهيم. أحد هذه المعجزات ظهرت لما أمر الملك الذي لم يؤمن بالرسالة الإلهية بأن يُحرق إبراهيم حيّا في محرقة عظيمة وأمام الناس، وكان التدخل الإلهي بأنّ النّار لم تحرق جسم إبراهيم، بل كانت بردًا وسلامًا عليه، فأحس بشيء من الانتعاش. فبالنسبة للذين شاهدوا المعجزة فالشكّ في الرسالة التي بُعث بها إبراهيم اندثر تماما وحلّ محله اليقين التّام، فالدّليل كان قاطعًا. وكان نفس الشيء مع موسى (عليه السلام) الذي أتى بالعديد من المعجزات. ولمّا غادر مصر مع قومه كان على موسى أن يقطع البحر، وبالقدرة التي وضعها الله في عصاه استطاع موسى أن يفتح طريقا في البحر وقطعه وقومه مشيا على الأقدام. وعيسى (عليه السلام) أتى بمعجزات لتشهد بصدق رسالته. فبمجرد لمسة من يده كان يبرئ المرضى.
هذه المعجزات أدلّة لا ريب فيها بالنّسبة للذين شاهدوها، ولكن كلّ هذه المعجزات لم تعد مشاهدة مع غياب الذين أتوا بها. فكيف لأي إنسان في أي زمان كان أن تبلغه رسالة إلهية ومعها معجزة تؤيدها؟
القرآن يردّ على هذا السؤال. محمد (صلى الله عليه وسلم) آخر الأنبياء بلّغ رسالة الله مجسدة في القرآن، وموجهة للإنسانية جمعاء، وصالحة إلى نهاية العالم. فما هي معجزة محمد (صلى الله عليه وسلم)؟
إنه تحدّ موجود في القرآن نفسه. تحدى القرآن كائنا من كان وفي أي زمان، حتى يثبت للإنسانية أن هذا الكتاب هو كلام الله، أن يأتي بنصّ مثله سواء في الأسلوب أو في قوة التعبير. حتى ولو كانت المحاولة بقدر سورة واحدة من أقصر سوره.
في القرآن نستطيع أن نقرأ: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ الآية 88 سورة الاسراء.
﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الآية 38 سورة يونس.
وحتّى نتصوّر القوّة التي تمكّن بها القرآن من إعجاز النّاس الأوائل الذين علموا بهذا التحدي كان من الأنسب تعريف موجز بالظروف المحيطة بمجيء القرآن.
إنه في شبه الجزيرة العربية، في 610 من بداية التاريخ الميلادي، ابتدأ الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) رسالته، وكان سكّان شبه الجزيرة العربية، العرب، يعيشون في جاهلية لا يحسدون عليها، تاريخهم مليء بالحروب القبلية التي لا تنتهي والتي تنشب لأتفه الأسباب. وبالمقارنة مع القوى السياسية في ذلك العهد، البيزنطيين والفرس، كان إنتاج العرب الحرفي ضئيلاً للغاية. بينما عاداتهم ومعتقداتهم كانت جاهلية: كان أكثرهم من الوثنيين ويعبدون اكثر من ثلاث مائة إله. فالتشدد في عاداتهم، وكرههم للبنات، حتى أن الكثيرات منهن يوأدن عند الولادة، هي من الأدلّة على تعصّبهم وانحطاطهم. وفي وسط كل هذه العادات السيئة، تشرق قيمة يفتخر ويعتز بها العرب: إنها لغتهم. هذه اللغة التي يتكلمونها ببراعة فائقة حتى لو كان المتكلم من أبسط سكان الصحراء. وكان هناك الكثير من الشعراء، وقصائدهم لها قيمة كبيرة في مجتمعهم. وكانوا ينظّمون مسابقات في الشعر في مكة بمناسبة توافد الوثنيين للحج. وكان الفائز ينال شرف كتابة قصيدته بأحرف من ذهب كي تعلّق في الكعبة بين أصنام الآلهة المقدسة عندهم. فهكذا نستطيع أن نتصور إلى أي درجة كانت اللغة العربية في صميم حياة أهل مكة والعرب جميعا. وفي هذه الظروف جاء التحدي من القرآن للعرب في ما يتقنونه بامتياز.
لذلك نجد أن القرآن لا يمكن نسبته إلا إلى مصدر واحد من مصادر ثلاثة، لأنّه عربي اللغة والأسلوب، فإمّا أن ينسب إلى العرب أو إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) أو إلى الله عز وجل ولنرى الآن هل الفرضيتان الأولى والثانية مقنعتان أم لا. لمّا صدر التحدي بالإتيان بمثل القرآن، كان الإسلام، الدين الجديد، يغزو العقول والقلوب في مكة لدرجة بدأت تقض مضاجع أصحاب السيادة والقوة في المجتمع المكي، ذلك أن الإسلام تصدى لقريش وآلهتها وعقائدها وأفكارها فبين زيفها وفسادها وخطأها وعابها وهاجمها كما هاجم كل العقائد والأفكار الموجودة. وكانت الآيات تنزل متلاحقة بذلك وتنزل مهاجمة لما كانوا يقومون به من أكل الربا، ووأد البنات وتطفيف الكيل واقتراف الزنا، كما كانت تنزل بمهاجمة زعماء قريش وسادتها، وتسفههم وتسفه دين آبائهم وأحلامهم وتفضح ما يقومون به من تآمر ضد الإسلام. الكثير من الناس دخلوا في الإسلام فقط لسماعهم القرآن البديع الأسلوب والمعنى، أمّا أعداء الدعوة من سادة قريش الخائفون على زوال نفوذهم ومصالحهم الدنيوية، والعرب الذين تصدوا للإسلام الذي لا يزال في المهد، فكان الأولى والأجدر بهم أن يردّوا على تحدي القرآن لو كان ذلك في مقدرتهم. ولكانوا أثبتوا بذلك أنّ إنسانا يقدر على كتابة نص بنفس قوة النص القرآني، وأنّ القرآن في النّهاية ما هو إلّا عمل بشري. ولكنهم بدلًا من ذلك عمدوا إلى العنف المادي والنفسي لمحاولة وأد الدين في مهده. هذا التصرف دلّ على عدم قدرتهم على مجابهة التحدي ومجابهة الإسلام بالفكر والدليل الذي كان من المفروض أن يكون الحل الأسهل، وبهذا يتضح أنه لا يمكن نسبة القرآن إلى العرب والتحدي قد وُجه إليهم بالأساس. أما الفرضية الثانية فتشير إلى أن القرآن هو من إبداع محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأنّ هذه عبقرية منه.
فتفسير عجز فطاحلة اللغة – العرب – أمام القرآن بوصف محمد (صلى الله عليه وسلم) بالعبقريّ الذي جاء بالقرآن من عنده تفسير غير مقنع. فالتاريخ عدّد لنا أمثلة كثيرة من العباقرة حتى أنه بإمكاننا أن نعطي مفهوما دقيقا لهذا اللفظ. فالذي يجمع بين كل العباقرة، أنّهم بالإضافة إلى كونهم موهوبين في مجالاتهم فإنّهم يتمتعون بحيوية عقلية أكبر بكثير من المعدل الطبيعي. وهذا ما يجعلهم يبدعون في مجال من المجالات. فالفزيائي (آينشتاين) مثلاً قد مكَّنه هذا التفوق من الوصول قبل غيره إلى نظريته الشهيرة المتعلقة بالنسبية، وإدخال مفاهيم جديدة مكنت من الانتباه إلى بعض الظواهر الفيزيائية. ولكن شهرة (آينشتاين) وأعماله لا يمكن أن تنسينا أنه في عصره وجد العديد من العلماء الكبار الذين ساهموا بفعالية في التقدم العلمي. ففي مجال الميكانيكا الكمية ظهر في عصر (آينشتاين) باحثون من أمثال (فيرمي) و(بوهر) و(شرودنجر)، وقد تركوا كذلك أثرهم في التاريخ. فهؤلاء العلماء كان باستطاعتهم فهم أعمال (آينشتاين) لدرجة أنّهم تمكنوا من إعادة صياغتها بل ونقدها أيضا. وهذا الأمر يمكن تعميمه: إذا تميز عبقري في مجتمع معيّن سنجد في نفس هذا المجتمع أشخاصا آخرين يمكن أن يصلوا إلى مستواه. فالعبقري لا يمكنه أن يتحدى ويُعجز كل إنسان في كل مكان وكل زمان أن يقوم بأعمال في مستوى أعماله.
في النهاية، العبقري هو قبل كل شيء إنسان محدود في طاقته البدنية والعقلية. فإذا كان قادرا على الإبداع فآخرون يمكنهم مضاهاته وحتى التفوق عليه، وما هي في الغالب إلّا مسألة وقت. أما القرآن فهو يعجز الإنسانية جمعاء منذ 14 قرنا، بداية من أولئك الذين كانوا يتقنون اللغة العربية بدرجة أكبر بكثير من الناطقين بها في عصرنا هذا. ونؤكِّد هنا على نقطة وهي: أنّ القرآن كما يتحدى الناطق باللسان العربي يتحدى أيضا الإنسان الذي لا يعرف أي كلمة من العربية. فكيف سنحس بقوة القرآن إذا لم نكن نستطيع قراءة العربية أو أن مستوانا ضعيف نسبيا فيها، فهل سنقف؟ لا، بل يكفي ملاحظة تصرف أصحاب اللّسان العربيِّ الأكثر اتقانا للعربيّةِ مقابِل تحدي القرآنِ لهم واستخلاص النّتيجة. فمثلاً: إن لم نكن نحن بذاتنا نمارس ألعاب القوى، ولكن كنّا متابعين لأخبار ألعاب القوى، نستطيع التأكيد بكل بساطة بأن قطع مسافة 100 متر في 10 ثوان هو في متناول أسْرعِ العدّائين. بينما في المقابل، لو أنّ رجلا تحدّى الجميع أن يصلوا إلى نفس سرعته في العدو وقطع 100 متر في ثانية واحدة، وأنت تعلم أنّ أبْطال العدْوِ العالمِيين يقِرّون بعجزهِم ولا يجْرؤون حتّى أن يحلموا بمجرّدِ الإِقترابِ مِن هذا الرقمِ القياسيِ لهذا الإنسان، فلن تجد أيّ تفسير إلّا تدخّل العناية الإلهية لمصلحتِه. ونفس الشيء عند ملاحظة حالة أكثر الناسِ اتقانا للّغةِ العربيةِ وهم عاجِزون تماما أمام تحدي القرآن، وبهذا نصل إلى نتيجة واحدة قطعية:
الشكل الأدبِيّ للقرآن ليس في متناول البشر، إذًا، فمن خلق البشر وخلق القدرة في البشرِ على الكلامِ هو المصدر الحتمي للقرآن وهو الله سبحانه وتعالى.
ولا نستطيع التهرّب من هذه الحقيقة بادّعاءِ العبقريةِ لمحمد (صلى الله عليه وسلم). فهل وجدنا أبدا، في ذاكِرتنا الإنسانية، أن عبقريا استطاع أن يعجز قومه وكذلك كل الإنسانية، بأن يأتوا بنص مماثل حتى ولو لجزء بسيط من عمله الأدبي؟ لا، فإنه من غير المعقولِ نسبة القرآنِ إلى محمد بن عبدِ الله (صلى الله عليه وسلم). فلم يبقَ إلا الانصياع أمام التفسيرِ الوحيدِ الممكنِ: القرآن هو بدون أدنى شكّ كلام الله الخالق سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة مطلقة، والإنسان الذي يريد السعادة بكل إصرار، يجب أن يولي اهتماما شديدا بهذا الكتاب الذي لا تساوي كل الكنوز التي في الدنيا الكلام الذي يحتويه.