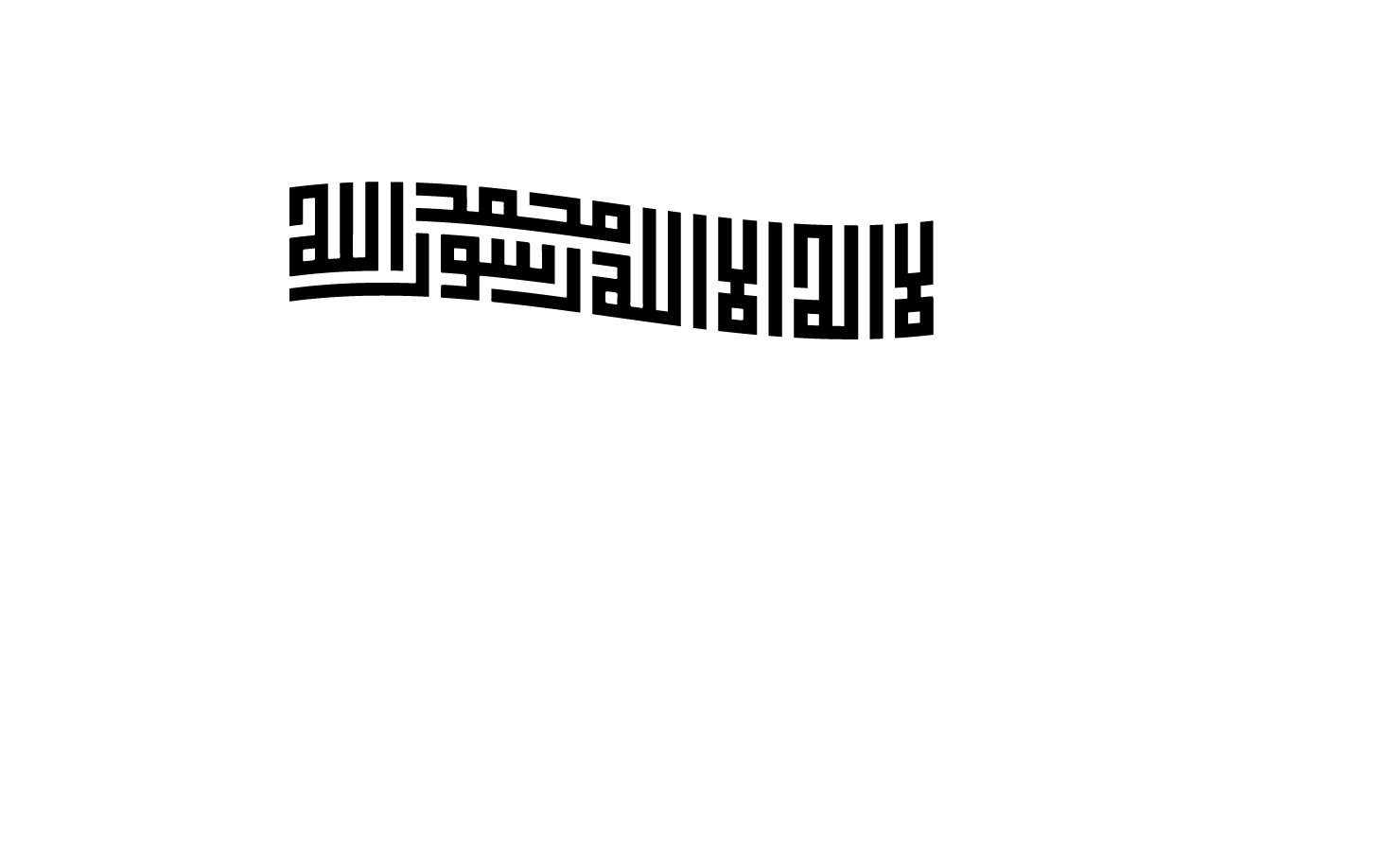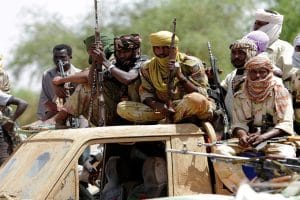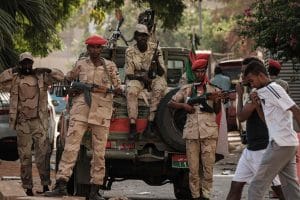كثيراً ما يساء الظن في المسار الذي يمكن أن ينهجه الإخوان المسلمون بعد توليتهم الحكم، فظن البعض أنهم يحملون إسلاماً إلى الحكم، كما كان حال صائب عريقات، الذي صرح حين فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بأن تجربة المشاركة بين فتح الداعية للسلام مع (إسرائيل) وحماس التي (كانت) ترفضه جملة وتفصيلاً، وادعت أنها تحمل نظاماً إسلامياً هي التجربة الأولى في التاريخ، وكان يقصد من ذلك استحالة المشاركة بين الجماعات المتناقضة. لذلك لا بد من فهم حقيقة ما يسمى بحركات الإسلام “المعتدلة” من الناحية السياسية في تجربتي مصر وتونس الحديثتين، ولا يقصد من ذلك دراسة شاملة لهاتين التجربتين، وإنما فهم واقع وجود هذه الحركات في الحكم في إطار نظام علماني وبمشاركة الحركات العلمانية، وفهمها من الناحية الشرعية، ومن ناحية أثر هذه التجارب في وصول الإسلام إلى الحكم، ومن ثم محاولة رسم مسار للعلاقة بين الحكم الإسلامي القادم قريباً إن شاء الله مع هذه الحركات.
وهنا تظهر للعيان مسألة بالغة الأهمية في الحياة السياسية، وهي الفرق في مفهوم الحكم بمعنى النظام والتشريع وبمعنى الإدارة. إن النظرة الخاطئة لواقع الحكم تؤدي إلى اعتباره مسألة إدارية كإدارة الشركات والمؤسسات، فتخلو من أذهان هؤلاء مسألة النظام والتشريع والقيادة السياسية التي تعني القوامة على المجتمع بمفهومها الشامل. وبالتأكيد فإنه لا يمكن قيادة أي أمة ولا أن تعتبر جماعة ما نفسها قوامة على الأمة من دون فكرة أساسية للحكم، وهذه الفكرة قد تكون مبدأ، وهذا ما يميز الجماعات التي تحمل الإسلام أو العلمانية أو تلك التي كانت تحمل الاشتراكية كفكرة للحكم، وقد تكون فكرة أخرى غير مبدئية مثل فكرة الحزب النازي الألماني عن تميز العرق الألماني عن باقي العروق، ومثل الفكرة القومية التي تثيرها مشاعر وأحاسيس القومية، فيأخذ الحزب الحاكم بقيادة البلاد في خدمة قومية ما على حساب قوميات أخرى كحال الأحزاب في روسيا وفي الكثير من دول العالم، أو حتى فكرة شديدة التعصب لقومية ما والتي يكون مخزون مشاعرها أحداثاً تاريخية جساماً مثل أحزاب الدولة الصهيونية التي لا يزال الهولوكوست عنصراً أساسياً في بنيتها المشاعرية وبالتالي أفكارها السياسية العملية، وباختصار فإن الحركة التي تتولى الحكم يجب أن يكون لديها فكرة ما للحكم بها وقيادة أمتها بهذه الفكرة، وبدون ذلك لا يمكن لأي حركة أن تقود أمة ما قيادة فعلية.
إن غياب الفكرة التي يقوم عليها الحكم وانعدام الرؤية الرعوية يؤدي إلى اعتبار الحكم والسياسة بمعنى رعاية شوؤن الأمة مجرد مسائل إدارية بحتة، وهذا وإن كان من الممكن أن يكتب له النجاح في بلدان مستقرة استقراراً تاماً كالدول الاسكندنافية إلا أنه يقود إلى الفشل حتماً في ظروف عدم الاستقرار سواء في مثالَي مصر وتونس التي تعصف بهما رياح عاتية ناجمة عن الثورة، وحتى في بلدان مستقرة نسبياً كالدول الأوروبية الكبرى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي تواجه أزمات في العلاقات الأوروبية الداخلية وداخل الاتحاد الأوروبي، وأن مسألة حل هذه الأزمات بحاجة إلى رؤية أكبر بكثير من الحسابات الإدارية للشركات.
وبناءً على هذا الفهم لواقع الحكم، فإن الحركات والجماعات التي تملك أفكاراً تطالب عادةً بالحكم وتسعى إليه حتى تتمكن من قيادة أمتها بأفكارها، وفي حالة الإخوان المسلمين وكذلك حركة النهضة الإخوانية في تونس فإنها في الأصل حركات غير سياسية فلم تكن لديها أفكار حكم، وبالتالي فإن هذه الحركات لم تطالب بالحكم أساساً، وهذه حقيقة تاريخية يؤدي تجاهلها إلى الوقوع في خطأ الاستنتاج.
وبالرجوع إلى تاريخ نشأة هذه الحركات تتبين بعض الحقائق بالغة الأهمية في فهم علاقة هذه الحركات بالحكم:
1- إن أصح ما يمكن استقراؤه من نشأة حركة الإخوان المسلمين وأخواتها في العالم العربي أنها في الأصل حركات جمعيات نشأت لسد ثغرة في المجتمع، تلك الثغرة كانت الالتزام بأحكام الإسلام الفردية، وهي لم تطرح يوماً ما برنامجاً للحكم، ولم تستهدف الحكم أبداً في تاريخها، وكان يرضيها من الحاكم أن ترى بجنبه سجادة صلاة، ولم تدخل يوماً ما في معترك الحياة السياسية إلا إذا أُفسح المجال أمامها وشقه غيرها كدعوة الحاكم لانتخابات نيابية. وعندما طرح المرحوم سيد قطب فكرة الحاكمية لله في كتابه الشهير معالم في الطريق، ضج الإخوان المسلمون ورفضوا الفكرة وأصدر الهضيبي المرشد العام للإخوان كتابه “دعاة لا قضاة” رداً على طروحات سيد. وبعد ذلك تطورت الحركة بحكم تضخم حجمها إلى العمل الخيري فأصبحت جمعية خيرية تعمل على بناء المساجد والمستشفيات وتوزيع المعونات الإنسانية في إطار أعضائها، بل إن توسع العمل الخيري فيها قد جعل أعضاءها في كثير من الأحيان منتفعين مادياً. وقد أخطأ الكثير من الحكام فهم جماعة الإخوان المسلمين، فتوجسوا منها خوفاً، لا سيما وأن قوى كبرى كانت تحاول استغلال هذه الجماعة والدفع بها في أتون الصراعات السياسية.
2- كانت حركة الإخوان من الناحية السياسية لا تخرج عن رأي الحاكم، فكان إخوان مصر لا يعادون مبارك في حكم مصر، وكذلك لم يكن إخوان الأردن يعادون الملك في عمان، لذلك ثارت بينهم مشادات كلامية حادة في أزمة الكويت سنة 1991م على أثر مناصرة إخوان الأردن للملك حسين في دعم العراق، ولم يتخذ إخوان مصر نفس الموقف المناصر للعراق بسبب أن مصر مبارك كانت تقف في الصف المعادي للعراق وقتها. وفي نفس السياق فقد كانت نشأة حركة النهضة في تونس نشأة مخابراتية بامتياز.
3- إن الشعبية التي تتمتع بها حركات الإسلام المعتدل والتي تناصرها في الانتخابات ليست شعبية حقيقية، وذلك أنها ناجمة تاريخياً عن عداء أنظمة الحكم للحركات الإسلامية المخلصة وإقفال كافة أبواب العمل السياسي أو المجتمعي أمامها في الوقت الذي تبقيه مفتوحاً للحركات المعتدلة. وقد أدى ذلك إلى توجه الشباب المندفع نحو الإسلام إلى تلك الحركات المعتدلة باعتبار أنها وحدها الموجودة في الساحة، وقد كان استثناءً من هذه القاعدة السياسة الحاقدة على كل ما يسمى إسلامياً من بن علي في تونس، فقام أيضاً بتضييق الخناق على حركة النهضة إخوانية التوجه.
وهذه الشعبية كانت ظاهرة للعيان بعد الربيع العربي حين طالبت الأمة بالتغيير في كل من مصر وتونس وظنت الأمة أن البديل للأنظمة القائمة يتمثل في هذه الحركات الإسلامية التي اعتادت بما تملكه من مخزون المشاعر الإسلامية أن ترفع شعار الإسلام هو الحل.
ويتسرب الخطأ أيضاً في فهم تجربة الإخوان في كل من تونس ومصر إذا خطر ببال أحد أن هذه الحركات قد أمسكت بالحكم نتيجة نضالها في مرحلة الربيع العربي، لأن الحقيقة أن هذه الحركات لم تكن أبداً في موقع القيادة في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت تلك البلدان، وإنما انخرط أفرادها ضمن الهبة الجماهيرية بشكل عادي قبل أن تبدأ الجماعة بتوجيه أفرادها للمظاهرات لأغراض محددة وتحجم عن المشاركة لأغراض أخرى. وكان الوضع في تونس أوضح حيث انتهت الهبة الجماهيرية التي شارك فيها أفراد حركة النهضة بصفتهم الفردية، وبدأت الحركة تنظم صفوفها بعد رحيل بن علي وبصورة بعيدة عن الذاتية، فكانت مشاركتها كحركة كبرى على الساحة التونسية بناءً على سياسات استعمارية إنجليزية.
وأما في مصر فقد كانت حركة الإخوان محط انتقاد الفئات الشعبية حتى قبل تنحي مبارك حين كان وفد الإخوان يفاوض عمر سليمان والثوار في الميدان لا يقبلون بأقل من رحيل مبارك، وكذلك في فترة حكم المجلس العسكري حين علت الشكوك المصرية في نوايا حركة الإخوان، الذين فازوا بمجلسي الشعب والشورى وأصبح تنسيقهم وتوافقهم مع المجلس العسكري ظاهراً للمصريين قبل أن يعصف بكل ذلك صمود الشعب المصري وإجباره المجلس العسكري على إجراء انتخابات رئاسية، وكان الإخوان قد تعهدوا قبل ذلك بعدم المشاركة فيها، إلا أنهم قد شاركوا فيها بزخم كبير، بعد أن أدركوا أن فوزهم في انتخابات مجلس الشورى لم يغير شيئاً، ولم يسمن ولم يغنِ من جوع، وأنهم به أعجز من المكسوح، فبعد تفاهمات مع الولايات المتحدة وتعهدهم على احترام الخطوط الحمراء الأمريكية في الداخل والخارج، وبالذات ما يتعلق باتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، فتحت لهم أمريكا الباب وضغطت على عملائها في مفاصل الدولة للسماح لمرشح الإخوان بخوض الانتخابات الرئاسية.
وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في كل من مصر وتونس بشكل منقوص، مكبلين من جهتين: بتعهداتهم أمام الغرب وعلى رأسه أمريكا من جهة، ومن فلول النظام السابق الذين مازالوا يمسكون بمفاصل الدولة من جهة أخرى، فمع وصولهم لم يصل الإسلام إلى الحكم في هذين البلدين، وحكم الرئيس مرسي في مصر وجماعة الغنوشي في تونس حكم هو أقبح من سابقه، فقد رفض الغنوشي مراراً فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية مع أن نجاح جماعته كان بناء على شعار “الإسلام هو الحل”، وأقدم الرئيس مرسي على أعمال شديدة الشناعة ما تأنفه نفس المسلم مثل فخره بدفع الربا في وقته، واستمرار بيع الغاز لـ (إسرائيل)، وإقفال الكثير من أنفاق غزة، والاستقبال المخزي لنجاد شريك جزار سوريا وغيرها كثير، هذا ناهيك عن غياب أي نسبة من أحكام الإسلام عن الحكم في مصر.
والذي يجب أن يكون واضحاً أن وصول الإخوان في كل من مصر وتونس إلى الحكم لم يكن بناءً على منهج واضح ومبلور، حتى أن الإخوان في مصر كانوا يرفضون في بداية الأمر فكرة الترشح لمنصب الرئاسة، وكانت القوى الدولية الكبرى التي تخشى من أن يقود الربيع العربي إلى ولادة دولة إسلامية تعمل على توحيد المنطقة هم من نصروا فكرة تسليم الحكم لمثل هذه الجماعات “الإسلامية المعتدلة” التي تقبل بالخطوط الحمراء الغربية، وهذا لم يكن خافياً على من يتابع النصائح التي تقدمها ومنذ فترة مراكز الدراسات والأبحاث الغربية لصناع القرار في تلك الدول بالاعتماد على هذه الحركات لمنع الإسلام الحقيقي من الوصول إلى الحكم، والآن تقوم تلك الدول بتطبيق هذه السياسات عملياً في مصر وتونس. ولعل الهدف المعلن من هذا التوجه الأمريكي والأوروبي إنما يهدف إلى امتصاص نقمة الجماهير العربية الحاقدة على الحكم العلماني وكذلك لدفع هذه الحركات المعتدلة للوقوف ضد الجماعات المخلصة التي تنادي بالتغيير الجذري وإقامة الخلافة الإسلامية.
وإذا كانت حركات الإخوان قد انخرطت بسذاجة تفكيرها في هذه السياسات الغربية ونجحت فعلاً في تحقيق امتصاص النقمة الجماهيرية على الحكام، إلا أنها قد فشلت تماماً في الوقوف ضد الجماعات الإسلامية المخلصة في مصر وتونس حيث يتوسع حزب التحرير وبقوة في هذين البلدين، ومن ناحية أخرى فإن نقمة الأمة قد تجددت وبسرعة ضد حكم الإخوان في مصر وتونس لتتحطم الآمال الغربية في نجاح هذه السياسة على المدى البعيد.
لقد تعالت مع احتجاجات الربيع العربي المطالبات الشعبية بتحكيم الإسلام، تلك المطالبات التي كانت عامة وعفوية، وقد نجح حكم الإخوان المسلمين في وقف زخمها وإصابتها بالإحباط، وقد أضرَّ ذلك فكرة تحكيم الإسلام كثيراً، وهو هدف مأمول للسياسات الغربية انساق في تحقيقه الإخوان المسلمون عن سذاجة، وقد هبطت الثقة الشعبية بالجماعات الإسلامية إجمالاً بعد هذه التجارب غير المشرفة، وأصبحت بحاجة إلى جهد مضاعف لتبيان أن هذه التجربة ليست نهاية المطاف ولم تكن أسلامية ابتداءً، وإذا استثنينا الآمال التي تعقدها الأمة على سوريا حيث يتضاءل تأثير الإخوان فيها، فإن جزءً من الأمة قد أصيب بحالة من الإحباط والهبوط في معنويات التغيير نتيجة انهيار الثقة بالإخوان المسلمين الذين ظنت بهم الأمة خيراً قبل استلامهم الحكم، بل إن الغرب المعادي للإسلام يحاول دس فكرة خبيثة مفادها أن هذه التجارب تعكس تماماً واقعية الحكم واستحالة التغيير الثوري، وسرعان ما اقتنع الإخوان بذلك تحت الضغط الغربي، فأبقوا على الجمهورية العلمانية في مصر وتونس ورسخوها، وأبقت مصر مرسي على العلاقات ذاتها مع (إسرائيل)، وأرسل مرسي سفيره إلى تل أبيب بعد أن كان مبارك قد سحبه، بل وتنفست جماعة مبارك الصعداء بأن شيئاً معيباً لم يطَلهم، وأخذوا يقولون صراحة بأن حكم مبارك كان أفضل من حكم المرشد…
وأما من زاوية السياسة الداخلية والنظرة الرعوية للأمة فقد برهنت هاتان التجربتان على الضعف الشديد في قدرات الإخوان على إدارة الأمور، ولم يكن منظوراً أن يكون بهذا القدر من السوء. فقد تجلت النظرة الفئوية البحتة في الحكومة الإخوانية مصحوبة بالمنافع المادية، حتى إن بعض الوظائف الحكومية المصرية تعلن داخلياً في إطار جماعة الإخوان، ويستفيد الإخوان بشكل مركز من الوزارات الاجتماعية والتموين لخدمة أعضاء الجماعة وأنصارها المنتخبين بسلع منخفضة الثمن، بشكل أوجد تقززاً وقرفاً داخل المجتمع المصري، ونظرة الانغلاق على النفس في داخل الجماعة وفي إطار الجماعة هي نظرة انعزالية جامدة وخطيرة على أصحابها، فهي نظرة لا تنظر للأمة التي تحكمها باعتبارها مكمن قوتها وأنها التربة التي تزرع فيها، فلا يثق الإخوان إلا بأنفسهم ويتوجسون خوفاً من غيرهم، وهذا يدفعهم للانغلاق، وبما أنهم في وضع الحاكم فإن هذا الانغلاق لا يجوز، إذ لا تحكم جماعة نفسها، بل تحكم أمتها التي يجب أن تكون محل ثقتها، وبها تصنع السياسات والقوة، وبغير ذلك لا يكون هناك أي معنى للحكم، فالانغلاق في الحكم هو حرمان الحكم من شرايين القوة التي تمد بها الأمة الدولة، وإذا انقطعت هذه الشرايين، بمعنى غياب تفاعل الأمة مع حكامها ساد التخلف والضعف ونبتت الشكوك والمؤامرات، وإذا وقفت جماعة ما في الحكم لا هم لها سوى الدفاع عن وجودها في الحكم بشتى الوسائل، وأصبح ذلك محوراً رئيسياً لها انتهى حكمها ووجب عليها المغاردة، فأمم الحكم الجبري هي فقط التي تحكم بشكل دائم بالحديد والنار.
وفي تونس تجلت النظرة الإدارية الخالية من أي بعد رعوي وأفشلت مخططات النهضة التنموية، فبعد أن وعدت الحركة بإيجاد مئات آلاف فرص العمل للتونسيين وقفت الدولة التونسية على حافة الهاوية الاقتصادية، لا تستطيع دفع رواتب موظفيها الذين كان بن علي يدفع رواتبهم بانتظام، وسادت النفعية الشخصية، فقام رئيس الوزراء التونسي الجبالي – وهو أمين عام حركة النهضة – بطرح مبادرة لإخراج حركة النهضة من الحكم مقابل أن يبقى هو شخصياً رئيساً للوزراء تحت اسم التكنوقراط فور اندلاع أعمال العنف على أثر اغتيال شكري بلعيد.
وبالمجمل فإن وجود هذه الحركات في الحكم هو بمثابة دفع غير المهندس للقيام بأعمال هندسية وغير الطبيب لمداواة المرضى، وهذا التمثيل غير بعيد على الإطلاق عن تجربتي مصر وتونس، فحركة الإخوان وأختها النهضة لا تملك ثقافة سياسية حقيقية، ولا تستهدف بناء دولة ذات طابع خاص، بل إن الوعي السياسي الحقيقي غير موجود لدى هاتين الحركتين، وكذلك المفاهيم السياسية غير مبلورة على الإطلاق، وهذا يفسر الضعف الشديد في الأداء السياسي لهما، وهو ما يفسر من زاوية أخرى سرعة سقوطهما في المخططات الاستعمارية للولايات المتحدة وأوروبا، ويمكن للمرء أن يجزم بأن خطوة ما لا يتم اتخاذها دون استشارة سفارات الدول الكبرى في تونس والقاهرة، وهذا يفسر بعض ما أسماه المصريون بالخرف السياسي أو المراهقة السياسية عندما طرح المتشدق عصام العريان في مصر إعادة اليهود إلى مصر وترحيبها بهم إرضاءً لأمريكا.
وأخيراً وقف الكثير في كل من تونس ومصر يريدون إخراج الإخوان من الحكم، وظهرت حملات شديدة ضد حكم هؤلاء لا سيما وأن عصر الثورة لم ينتهِ بعد. وهذا وإن كان يشير إلى فشل السياسات الغربية في تثبيت ما يسمى بحركات الإسلام المعتدل ضد الحركات التي تسعى إلى التغيير الحقيقي بسرعة لفظ الشارع لهذه الحركات، إلا أن الغرب قد نجح ومن خلال هذه التجارب التي لم تنتهِ بعد في تسديد طعنة قوية للإسلام والحركات المخلصة على مستوى الزخم الشعبي، أي أن الغرب قد نجح في امتصاص الغضبة الشعبية التي صارت تعرف بالربيع العربي من أن تكتسي طابعاً إسلامياً حقيقياً، فقد تميَّعت الثقة الجماهيرية بالإسلام أمام مغامرات الإخوان السياسية.
وهنا أصبح البعض يحلو له القول بفشل الربيع الإسلامي، وأن العلمانية وفقط الحركات العلمانية هي القادرة على الحكم في المنطقة العربية، وتتصدر هذه الحملة وسائل الإعلام العلمانية التي تعكس رأي الحركات العلمانية والغرب، وذلك في استنتاج خبيث لا يذكرون فيه أن حركة الإخوان المسلمين دخلت في نظام علماني مخالف للإسلام، وأن هناك مراكز قوى في مفاصل هذا النظام تناوؤهم وتعمل على إفشالهم، وأن هذا النموذج لا يوجد فيه من الإسلام إلا اسمه، والبسملة قبل اللقاء التلفزيوني، وأن قيادات الحركة – دون قاعدتها – قد أحسنت الأداء في الانصياع للنصائح الغربية بدرجة فاقت مبارك وبن علي، بل وأنها أعلنت عدم تطبيقها للإسلام وإن كانت تتذرع بعدم قدرتها على ذلك، والتزامها الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية السلام مع (إسرائيل)، حتى أن رائحة الفساد فاحت من بعض رموزها، كالقضية التي تحوم حول وزير خارجية تونس، بل ويلحقها الإخوان في سوريا وتنسيقهم مع الغرب عدو الإسلام وداعم بشار، كما ظهر في اجتماعات البيانوني في ميونخ في مؤتمر الغرب للأمن العالمي.
حتى وإن برروا كل ذلك بالضرورة وعدم قدرتهم على مجابهة الغرب ووجوب التفاهم معه وتقديم التنازلات، فإن تماهي حركات ما يسمى بالإسلام المعتدل مع الغرب منقطع النظير، ومن الجدير بالعلمانيين في الغرب وفي المنطقة العربية أن يتجاوزوا الاسم وبعض هفوات الماضي وأن يعلنوا للعالم الإسلامي أن بوصول هذه الحركات “المعتدلة” إلى الحكم فإن المنطقة مازالت تسير بامتياز في ركاب الدول الاستعمارية.
بقيت مسألة واحدة، وهي كيف ستتعامل الدولة الإسلامية القادمة يقينا مع هذه الجماعات في ظل انكشاف علاقاتها مع الدول الاستعمارية الكافرة؟ إن الدولة الإسلامية التي سيتم إقامتها بواسطة الأمة ستنظر إلى هذه المسألة من منظورين: الأول شرعي، والثاني سياسي رعوي.
فمن الناحية الشرعية يحق لكل مجموعة من المسلمين تأسيس أحزاب وجماعات، ومن هنا لن يمنع أحد من العمل كحزب بشرط أن تكون أفكاره وأهدافه إسلامية، لكن هنا يحق للدولة الإسلامية أن تشترط قطع كل أنواع العلاقات بين هذه الأحزاب والدول الكافرة المستعمرة، وإذا ما تم فعلاً قطع هذه العلاقات فقد انتفى الخطر الاستعماري الذي يمكن أن يستغل هذه الجماعات في ظل ضحالة وعيها السياسي الإسلامي. ومن زاوية أخرى فإن ارتفاع الوعي الفكري والسياسي العام في الأمة بعد إقامة الدولة سيؤثر إيجابياً على هذه الجماعات بحيث يرتفع مستوى وعيها هي الأخرى، وتبني بالتالي جداراً وقائياً لاستغلالها من قبل أعداء الأمة، وإلا فستصبح مجموعات هامشية لا ثقل لها في المجتمع وفي التأثير السياسي.